( فصل ) في اللغة ، وأصلها : لغوة على وزن فعلة . من لغوت إذا تكلمت . وهي توقيف ووحي ، لا اصطلاح وتواطؤ على الأشهر . وذلك لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في تفسيره بسنده إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=31وعلم آدم الأسماء كلها } ) قال " علمه اسم كل شيء . حتى علمه القصعة والقصيعة ، والفسوة والفسية " ولما روى
ابن جرير في تفسيره من طريق
الضحاك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=31وعلم آدم الأسماء كلها } ) قال " هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس الآن نحو : إنسان ، دابة ، أرض ، سهل ، بحر ، جبل ، حمار . وأشباه ذلك من الأسماء وغيرها " .
ثم إن
nindex.php?page=treesubj&link=25817_20481_20890_20891_20894_20893ألفاظ اللغة تنقسم إلى متواردة ، وإلى مترادفة . فالمتواردة : كما تسمى الخمر عقارا . تسمى صهباء وقهوة ، والسبع : ليثا ، وأسدا وضرغاما . والمترادفة : هي التي يقام لفظ مقام لفظ ، لمعان متقاربة ، يجمعها معنى واحد ، كما يقال : أصلح الفاسد . ولم الشعث ، ورتق الفتق ، وشعب الصدع . وهذا يحتاج إليه البليغ في بلاغته . فبحسن الألفاظ واختلافها على المعنى الواحد ترصع المعاني في القلوب ، وتلتصق بالصدور ، وتزيد حسنه وحلاوته بضرب الأمثلة والتشبيهات المجازية . ثم تنقسم الألفاظ أيضا إلى مشتركة ، وإلى عامة مطلقة ، وتسمى مستغرقة
[ ص: 29 ] وإلى ما هو مفرد بإزاء مفرد . وسيأتي بيان ذلك .
والداعي إلى ذكر اللغة هاهنا : لكونها من الأمور المستمد منها هذا العلم ، وذلك أنه لما كان الاستدلال من الكتاب والسنة ، اللذين هما أصل الإجماع والقياس ، وكانا أفصح الكلام العربي : احتيج إلى معرفة لغة
العرب ، لتوقف الاستدلال منهما عليها .
فإن قيل : من سبق نبينا
محمدا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين ، إنما كان مبعوثا لقومه خاصة فهو مبعوث بلسانهم ،
nindex.php?page=treesubj&link=20481_25034ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث لجميع الخلق . فلم لم يبعث بجميع الألسنة ، ولم يبعث إلا بلسان بعضهم ، وهم
العرب ؟ فالجواب : أنه لو بعث بلسان جميعهم ، لكان كلامه خارجا عن المعهود ، ويبعد بل يستحيل - أن ترد كل كلمة من القرآن مكررة بكل الألسنة . فيتعين البعض . وكان لسان
العرب أحق ، لأنه أوسع وأفصح ، ولأنه لسان المخاطبين ، وإن كان الحكم عليهم وعلى غيرهم . ولما خلق الله تعالى النوع الإنساني ، وجعله محتاجا لأمور لا يستقل بها ، بل يحتاج فيها إلى المعاونة : كان لا بد للمعاون من الاطلاع على ما في نفس المحتاج بشيء يدل عليه : من لفظ ، أو إشارة ، أو كتابة أو مثال أو نحوه .
إذا تقرر هذا ف ( اللغة ) في الدلالة على ذلك ( أفيد ) أي أكثر فائدة ( من غيرها ) لأن اللفظ يقع على المعدوم والموجود ، والحاضر الحسي والمعنوي ( وأيسر لخفتها ) لأن الحروف كيفيات تعرض للنفس الضروري ، فلا يتكلف لها ما يتكلف لغيرها ( وسببها ) أي سبب وضعها ( حاجة الناس ) إليها . قال
إلكيا الهراسي : إن الإنسان لما لم يكن مكتفيا بنفسه في مهماته ومقيمات معاشه : لم يكن له بد من أن يسترفد المعاونة من غيره ولهذا المعنى اتخذ الناس المدن ليجتمعوا ويتعاونوا " انتهى .
قال : بعضهم : ولهذا المعنى توزعت الصنائع وانقسمت الحرف على الخلق . فكل واحد قصر وقته على حرفة يستقل بها ، لأن كل واحد من الخلق لا يمكنه أن يقوم بجملة مقاصده . فحينئذ لا يخلو من أن يكون محل حاجته حاضرة عنده أو غائبة بعيدة عنه فإن كانت حاضرة أشار إليها ، وإن كانت غائبة ، فلا بد له من أن يدل بشيء
[ ص: 30 ] على محل حاجته . فوضعوا الكلام دلالة ، ووجدوا اللسان أسرع الأعضاء حركة وقبولا للترداد ، وكان الكلام إنما يدل بالصوت . وكان الصوت إن ترك سدى ، امتد وطال ، وإن قطع تقطع ، قطعوه وجزءوه على حركات أعضاء الإنسان التي يخرج منها الصوت ، وهي من أقصى الرئة إلى منتهى الفم . فوجدوه تسعة وعشرين حرفا ، قسموها على الحلق والصدر ، والشفة واللثة ، ثم لما رأوا أن الكفاية لا تقع بهذه الحروف ركبوا منها ثنائيا وثلاثيا ورباعيا وخماسيا واستثقلوا ما زاد على ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : وإنما كان نوع الإنسان أكثر حاجة من جميع الحيوانات لأن غيره قد يستقل بنفسه عن جنسه أما الإنسان : فمطبوع على الافتقار إلى جنسه في الاستعانة ، فهو صفة لازمة لطبعه وخلقه ، قائمة في جوهره .
وقال
ابن مفلح وغيره : سبب وجودها . حاجة الناس ليعرف بعضهم مراد بعض للتساعد والتعاضد بما لا مؤنة فيه لخفتها ، وكثرة فائدتها ، ولا محذور . وهذا من نعم الله تعالى على عباده . فمن تمام نعمه علينا : أن جعل ذلك بالنطق دون غيره ( وهي ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=20824وحقيقة اللغة ( ألفاظ وضعت لمعان ) يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ، فلا يدخل المهمل ; لأنه لم يوضع لمعنى ( فما الحاجة إليه ) أي فالمعنى الذي يحتاج الإنسان إلى الاطلاع عليه من نفسه دائما ، كطلب ما يدفع به عن نفسه من ألم جوع ، أو عطش ، أو حر ، أو برد ( والظاهر : أو كثرت ) حاجته إليه . كالمعاملات ( لم تخل من ) وضع ( لفظ له ، ويجوز خلوها من لفظ لعكسهما ) وهما ما لا يحتاج إليه ألبتة ، أو تقل الحاجة إليه . قال
ابن حمدان في مقنعه : ما احتاج الناس إليه لم تخل اللغة من لفظ يفيده ، وما لم يحتاجوا إليه يجوز خلوها عما يدل عليه ، وما دعت الحاجة إليه غالبا . فالظاهر عدم خلوها عنه ، وعكسه بعكسه انتهى . قال في شرح التحرير : وحاصله : أن معنا أربعة
[ ص: 31 ] أقسام . أحدها : ما احتاجه الناس واضطروا إليه . فلا بد لهم من وضعه . الثاني : عكسه ، ما لا يحتاج إليه ألبتة ، يجوز خلوها عنه ، وخلوها - والله أعلم - أكثر .
الثالث : ما كثرت الحاجة إليه ، الظاهر عدم خلوها ، بل هو كالمقطوع به .
الرابع : عكسه ، ما قلت الحاجة إليه ، يجوز خلوها عنه ، وليس بممتنع .
( والصوت ) الحاصل عند اصطكاك الأجرام ( عرض مسموع ) وسببه انضغاط الهواء بين الجرمين ، فيتموج تموجا شديدا ، فيخرج فيقرع صماخ الأذن فتدركه قوة السمع ، فصوت المتكلم : عرض حاصل عن اصطكاك أجرام الفم ، وهي مخارج الحروف ودفع النفس للهواء ، متكيفا بصورة كلام المتكلم إلى أذن السامع وقولهم " الصوت " عرض ، يتناول جميع الأعراض ، وقولهم " مسموع " خرج جميعها ، إلا ما يدرك بالسمع . ( قلت : بل ) الأخلص في العبارة أن يقال : الصوت ( صفة مسموعة . والله أعلم ) .
قال في شرح التحرير : وإنما بدأنا بالصوت ; لأنه الجنس الأعلى للكلام الذي نحن بصدد الكلام عليه .
( واللفظ ) في اللغة : الرمي ، وفي الاصطلاح ( صوت معتمد على بعض مخارج الحروف ) لأن الصوت لخروجه من الفم صار كالجوهر المرمي منه . فهو ملفوظ . فأطلق اللفظ عليه من باب تسمية المفعول باسم المصدر ، كقولهم : نسج اليمين : أي منسوجه . إذا تقرر هذا ، فاللفظ الاصطلاحي : نوع للصوت ، لأنه صوت مخصوص . ولهذا أخذ الصوت في حد اللفظ ، وإنما يؤخذ في حد الشيء جنس ذلك الشيء .
( والقول ) في اللغة مجرد النطق ، وفي الاصطلاح ( لفظ وضع لمعنى ذهني ) لما كان اللفظ أعم من القول لشموله المهمل ، والمستعمل أخرج المهمل بقوله " وضع لمعنى " واختلف العلماء في قوله " وضع لمعنى " على ثلاثة أقوال . أحدها : ما في المتن ، وهو المعنى الذهني ، وهو ما يتصوره العقل ، سواء طابق ما في الخارج أو لا ، لدوران الألفاظ مع المعاني الذهنية وجودا وعدما . وهذا القول
[ ص: 32 ] اختاره
الرازي وأتباعه ،
وابن حمدان ،
وابن قاضي الجبل من أصحابنا . والقول الثاني : أنه وضع للمعنى الخارجي ، أي الموجود في الخارج . وبه قطع
nindex.php?page=showalam&ids=11815أبو إسحاق الشيرازي . والقول الثالث : أنه وضع للمعنى من حيث هو من غير ملاحظة كونه في الذهن ، أو في الخارج . واختاره
السبكي الكبير ، ومحل الخلاف في الاسم النكرة .
nindex.php?page=treesubj&link=20825_20826 ( والوضع ) نوعان . وضع ( خاص ، وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى ) الموضوع له ، أي جعل اللفظ متهيئا لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على وجه مخصوص . وقولنا ( ولو مجازا ) ليشمل المنقول من شرعي وعرفي . قال في شرح التحرير : وهذا هو الصحيح .
( و ) نوع ( عام ، وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه . كالمقادير ) أي كجعل المقادير دالة على مقدراتها من مكيل وموزون ومعدود ومزروع وغيرها .
وفي كلا النوعين الوضع : أمر متعلق بالواضع ( والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى ) أي إرادة مسمى اللفظ بالحكم ، وهو الحقيقة ، أو غير مسماه لعلاقة بينهما ، وهو المجاز ، وهو من صفات المتكلم ( والحمل : اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه ) أو ما اشتمل على مراده . فالمراد : كاعتقاد الحنبلي والحنفي : أن الله تعالى أراد بلفظ القرء : الحيض ، والمالكي والشافعي : أن الله تعالى أراد به : الطهر . وهذا من صفات السامع . فالوضع سابق ، والحمل لاحق ، والاستعمال متوسط .
( فَصْلٌ ) فِي اللُّغَةِ ، وَأَصْلُهَا : لِغْوَةٌ عَلَى وَزْنِ فِعْلَةٌ . مِنْ لَغَوْت إذَا تَكَلَّمْت . وَهِيَ تَوْقِيفٌ وَوَحْيٌ ، لَا اصْطِلَاحٌ وَتَوَاطُؤٌ عَلَى الْأَشْهَرِ . وَذَلِكَ لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ فِي تَفْسِيرِهِ بِسَنَدِهِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=31وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا } ) قَالَ " عَلَّمَهُ اسْمَ كُلِّ شَيْءٍ . حَتَّى عَلَّمَهُ الْقَصْعَةَ وَالْقُصَيْعَةَ ، وَالْفَسْوَةَ وَالْفُسَيَّةَ " وَلِمَا رَوَى
ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ
الضَّحَّاكِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=31وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا } ) قَالَ " هِيَ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ الَّتِي يَتَعَارَفُ بِهَا النَّاسُ الْآنَ نَحْوُ : إنْسَانٌ ، دَابَّةٌ ، أَرْضٌ ، سَهْلٌ ، بَحْرٌ ، جَبَلٌ ، حِمَارٌ . وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْمَاءِ وَغَيْرِهَا " .
ثُمَّ إنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25817_20481_20890_20891_20894_20893أَلْفَاظَ اللُّغَةِ تَنْقَسِمُ إلَى مُتَوَارِدَةٍ ، وَإِلَى مُتَرَادِفَةٍ . فَالْمُتَوَارِدَةُ : كَمَا تُسَمَّى الْخَمْرُ عُقَارًا . تُسَمَّى صَهْبَاءَ وَقَهْوَةً ، وَالسَّبُعَ : لَيْثًا ، وَأَسَدًا وَضِرْغَامًا . وَالْمُتَرَادِفَةُ : هِيَ الَّتِي يُقَامُ لَفْظٌ مَقَامَ لَفْظٍ ، لَمَعَانٍ مُتَقَارِبَةٍ ، يَجْمَعُهَا مَعْنًى وَاحِدٌ ، كَمَا يُقَالُ : أَصْلَحَ الْفَاسِدَ . وَلَمَّ الشَّعَثَ ، وَرَتَقَ الْفَتْقَ ، وَشَعَبَ الصَّدْعَ . وَهَذَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْبَلِيغُ فِي بَلَاغَتِهِ . فَبِحُسْنِ الْأَلْفَاظِ وَاخْتِلَافِهَا عَلَى الْمَعْنَى الْوَاحِدِ تُرَصَّعُ الْمَعَانِي فِي الْقُلُوبِ ، وَتَلْتَصِقُ بِالصُّدُورِ ، وَتَزِيدُ حُسْنَهُ وَحَلَاوَتَهُ بِضَرْبِ الْأَمْثِلَةِ وَالتَّشْبِيهَاتِ الْمَجَازِيَّةِ . ثُمَّ تَنْقَسِمُ الْأَلْفَاظُ أَيْضًا إلَى مُشْتَرَكَةٍ ، وَإِلَى عَامَّةٍ مُطْلَقَةٍ ، وَتُسَمَّى مُسْتَغْرِقَةً
[ ص: 29 ] وَإِلَى مَا هُوَ مُفْرَدٌ بِإِزَاءِ مُفْرَدٍ . وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ .
وَالدَّاعِي إلَى ذِكْرِ اللُّغَةِ هَاهُنَا : لِكَوْنِهَا مِنْ الْأُمُورِ الْمُسْتَمَدِّ مِنْهَا هَذَا الْعِلْمُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الِاسْتِدْلَال مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، اللَّذَيْنِ هُمَا أَصْلُ الْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ ، وَكَانَا أَفْصَحَ الْكَلَامِ الْعَرَبِيِّ : اُحْتِيجَ إلَى مَعْرِفَةِ لُغَةِ
الْعَرَبِ ، لِتَوَقُّفِ الِاسْتِدْلَالِ مِنْهُمَا عَلَيْهَا .
فَإِنْ قِيلَ : مَنْ سَبَقَ نَبِيَّنَا
مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، إنَّمَا كَانَ مَبْعُوثًا لِقَوْمِهِ خَاصَّةً فَهُوَ مَبْعُوثٌ بِلِسَانِهِمْ ،
nindex.php?page=treesubj&link=20481_25034وَنَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْعُوثٌ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ . فَلِمَ لَمْ يُبْعَثْ بِجَمِيعِ الْأَلْسِنَةِ ، وَلَمْ يُبْعَثْ إلَّا بِلِسَانِ بَعْضِهِمْ ، وَهُمْ
الْعَرَبُ ؟ فَالْجَوَابُ : أَنَّهُ لَوْ بُعِثَ بِلِسَانِ جَمِيعِهِمْ ، لَكَانَ كَلَامُهُ خَارِجًا عَنْ الْمَعْهُودِ ، وَيَبْعُدُ بَلْ يَسْتَحِيلُ - أَنْ تَرِدَ كُلُّ كَلِمَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ مُكَرَّرَةً بِكُلِّ الْأَلْسِنَةِ . فَيَتَعَيَّنُ الْبَعْضُ . وَكَانَ لِسَانُ
الْعَرَبِ أَحَقَّ ، لِأَنَّهُ أَوْسَعُ وَأَفْصَحُ ، وَلِأَنَّهُ لِسَانُ الْمُخَاطَبِينَ ، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ . وَلَمَّا خَلْقَ اللَّهُ تَعَالَى النَّوْعَ الْإِنْسَانِيَّ ، وَجَعَلَهُ مُحْتَاجًا لِأُمُورٍ لَا يَسْتَقِلُّ بِهَا ، بَلْ يَحْتَاجُ فِيهَا إلَى الْمُعَاوَنَةِ : كَانَ لَا بُدَّ لِلْمُعَاوِنِ مِنْ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْمُحْتَاجِ بِشَيْءٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ : مِنْ لَفْظٍ ، أَوْ إشَارَةٍ ، أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ مِثَالٍ أَوْ نَحْوِهِ .
إذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَ ( اللُّغَةُ ) فِي الدَّلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ ( أَفْيَدُ ) أَيْ أَكْثَرُ فَائِدَةً ( مِنْ غَيْرِهَا ) لِأَنَّ اللَّفْظَ يَقَعُ عَلَى الْمَعْدُومِ وَالْمَوْجُودِ ، وَالْحَاضِرِ الْحِسِّيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ ( وَأَيْسَرُ لِخِفَّتِهَا ) لِأَنَّ الْحُرُوفَ كَيْفِيَّاتٌ تَعْرِضُ لِلنَّفَسِ الضَّرُورِيِّ ، فَلَا يَتَكَلَّفُ لَهَا مَا يَتَكَلَّفُ لِغَيْرِهَا ( وَسَبَبُهَا ) أَيْ سَبَبُ وَضْعِهَا ( حَاجَةُ النَّاسِ ) إلَيْهَا . قَالَ
إلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ : إنَّ الْإِنْسَانَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مُكْتَفِيًا بِنَفْسِهِ فِي مُهِمَّاتِهِ وَمُقِيمَاتِ مَعَاشِهِ : لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنْ أَنْ يَسْتَرْفِدَ الْمُعَاوَنَةَ مِنْ غَيْرِهِ وَلِهَذَا الْمَعْنَى اتَّخَذَ النَّاسُ الْمُدُنَ لِيَجْتَمِعُوا وَيَتَعَاوَنُوا " انْتَهَى .
قَالَ : بَعْضُهُمْ : وَلِهَذَا الْمَعْنَى تَوَزَّعَتْ الصَّنَائِعُ وَانْقَسَمَتْ الْحِرَفُ عَلَى الْخَلْقِ . فَكُلُّ وَاحِدٍ قَصَرَ وَقْتَهُ عَلَى حِرْفَةٍ يَسْتَقِلُّ بِهَا ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْخَلْقِ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُومَ بِجُمْلَةِ مَقَاصِدِهِ . فَحِينَئِذٍ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ حَاجَتِهِ حَاضِرَةً عِنْدَهُ أَوْ غَائِبَةً بَعِيدَةً عَنْهُ فَإِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً أَشَارَ إلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً ، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَدُلَّ بِشَيْءٍ
[ ص: 30 ] عَلَى مَحَلِّ حَاجَتِهِ . فَوَضَعُوا الْكَلَامَ دَلَالَةً ، وَوَجَدُوا اللِّسَانَ أَسْرَعَ الْأَعْضَاءِ حَرَكَةً وَقَبُولًا لِلتَّرْدَادِ ، وَكَانَ الْكَلَامُ إنَّمَا يَدُلُّ بِالصَّوْتِ . وَكَانَ الصَّوْتُ إنْ تُرِكَ سُدًى ، امْتَدَّ وَطَالَ ، وَإِنْ قُطِعَ تَقَطَّعَ ، قَطَّعُوهُ وَجَزَّءُوهُ عَلَى حَرَكَاتِ أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا الصَّوْتُ ، وَهِيَ مِنْ أَقْصَى الرِّئَةِ إلَى مُنْتَهَى الْفَمِ . فَوَجَدُوهُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ حَرْفًا ، قَسَّمُوهَا عَلَى الْحَلْقِ وَالصَّدْرِ ، وَالشَّفَةِ وَاللِّثَةِ ، ثُمَّ لَمَّا رَأَوْا أَنَّ الْكِفَايَةَ لَا تَقَعُ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ رَكَّبُوا مِنْهَا ثُنَائِيًّا وَثُلَاثِيًّا وَرُبَاعِيًّا وَخُمَاسِيًّا وَاسْتَثْقَلُوا مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15151الْمَاوَرْدِيُّ : وَإِنَّمَا كَانَ نَوْعُ الْإِنْسَانِ أَكْثَرَ حَاجَةً مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ لِأَنَّ غَيْرَهُ قَدْ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ عَنْ جِنْسِهِ أَمَّا الْإِنْسَانُ : فَمَطْبُوعٌ عَلَى الِافْتِقَارِ إلَى جِنْسِهِ فِي الِاسْتِعَانَةِ ، فَهُوَ صِفَةٌ لَازِمَةٌ لِطَبْعِهِ وَخَلْقِهِ ، قَائِمَةٌ فِي جَوْهَرِهِ .
وَقَالَ
ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ : سَبَبُ وُجُودِهَا . حَاجَةُ النَّاسِ لِيَعْرِفَ بَعْضُهُمْ مُرَادَ بَعْضٍ لِلتَّسَاعُدِ وَالتَّعَاضُدِ بِمَا لَا مُؤْنَةَ فِيهِ لِخِفَّتِهَا ، وَكَثْرَةِ فَائِدَتِهَا ، وَلَا مَحْذُورَ . وَهَذَا مِنْ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ . فَمِنْ تَمَامِ نِعَمِهِ عَلَيْنَا : أَنْ جَعَلَ ذَلِكَ بِالنُّطْقِ دُونَ غَيْرِهِ ( وَهِيَ ) أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=20824وَحَقِيقَةُ اللُّغَةِ ( أَلْفَاظٌ وُضِعَتْ لِمَعَانٍ ) يُعَبِّرُ بِهَا كُلُّ قَوْمٍ عَنْ أَغْرَاضِهِمْ ، فَلَا يَدْخُلُ الْمُهْمَلُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لِمَعْنًى ( فَمَا الْحَاجَةُ إلَيْهِ ) أَيْ فَالْمَعْنَى الَّذِي يَحْتَاجُ الْإِنْسَانُ إلَى الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ دَائِمًا ، كَطَلَبِ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ أَلَمِ جُوعٍ ، أَوْ عَطَشٍ ، أَوْ حَرٍّ ، أَوْ بَرْدٍ ( وَالظَّاهِرُ : أَوْ كَثُرَتْ ) حَاجَتُهُ إلَيْهِ . كَالْمُعَامَلَاتِ ( لَمْ تَخْلُ مِنْ ) وَضْعِ ( لَفْظٍ لَهُ ، وَيَجُوزُ خُلُوُّهَا مِنْ لَفْظٍ لِعَكْسِهِمَا ) وَهُمَا مَا لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ أَلْبَتَّةَ ، أَوْ تَقِلُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ . قَالَ
ابْنُ حَمْدَانَ فِي مُقَنَّعِهِ : مَا احْتَاجَ النَّاسُ إلَيْهِ لَمْ تَخْلُ اللُّغَةُ مِنْ لَفْظٍ يُفِيدُهُ ، وَمَا لَمْ يَحْتَاجُوا إلَيْهِ يَجُوزُ خُلُوُّهَا عَمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَمَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ غَالِبًا . فَالظَّاهِرُ عَدَمُ خُلُوِّهَا عَنْهُ ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ انْتَهَى . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَحَاصِلُهُ : أَنَّ مَعَنَا أَرْبَعَةَ
[ ص: 31 ] أَقْسَامٍ . أَحَدُهَا : مَا احْتَاجَهُ النَّاسُ وَاضْطُرُّوا إلَيْهِ . فَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ وَضْعِهِ . الثَّانِي : عَكْسُهُ ، مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَلْبَتَّةَ ، يَجُوزُ خُلُوُّهَا عَنْهُ ، وَخُلُوُّهَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَكْثَرَ .
الثَّالِثُ : مَا كَثُرَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ ، الظَّاهِرُ عَدَمُ خُلُوِّهَا ، بَلْ هُوَ كَالْمَقْطُوعِ بِهِ .
الرَّابِعُ : عَكْسُهُ ، مَا قَلَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ ، يَجُوزُ خُلُوُّهَا عَنْهُ ، وَلَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ .
( وَالصَّوْتُ ) الْحَاصِلُ عِنْدَ اصْطِكَاكِ الْأَجْرَامِ ( عَرَضٌ مَسْمُوعٌ ) وَسَبَبُهُ انْضِغَاطُ الْهَوَاءِ بَيْنَ الْجِرْمَيْنِ ، فَيَتَمَوَّجُ تَمَوُّجًا شَدِيدًا ، فَيَخْرُجُ فَيَقْرَعُ صِمَاخَ الْأُذُنِ فَتُدْرِكُهُ قُوَّةُ السَّمْعِ ، فَصَوْتُ الْمُتَكَلِّمِ : عَرَضٌ حَاصِلٌ عَنْ اصْطِكَاكِ أَجْرَامِ الْفَمِ ، وَهِيَ مَخَارِجُ الْحُرُوفِ وَدَفْعُ النَّفَسِ لِلْهَوَاءِ ، مُتَكَيِّفًا بِصُورَةِ كَلَامِ الْمُتَكَلِّمِ إلَى أُذُنِ السَّامِعِ وَقَوْلُهُمْ " الصَّوْتُ " عَرَضٌ ، يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْأَعْرَاضِ ، وَقَوْلُهُمْ " مَسْمُوعٌ " خَرَجَ جَمِيعُهَا ، إلَّا مَا يُدْرَكُ بِالسَّمْعِ . ( قُلْت : بَلْ ) الْأَخْلَصُ فِي الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ : الصَّوْتُ ( صِفَةٌ مَسْمُوعَةٌ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) .
قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَإِنَّمَا بَدَأْنَا بِالصَّوْتِ ; لِأَنَّهُ الْجِنْسُ الْأَعْلَى لِلْكَلَامِ الَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ .
( وَاللَّفْظُ ) فِي اللُّغَةِ : الرَّمْيُ ، وَفِي الِاصْطِلَاحِ ( صَوْتٌ مُعْتَمِدٌ عَلَى بَعْضِ مَخَارِجِ الْحُرُوفِ ) لِأَنَّ الصَّوْتَ لِخُرُوجِهِ مِنْ الْفَمِ صَارَ كَالْجَوْهَرِ الْمَرْمِيِّ مِنْهُ . فَهُوَ مَلْفُوظٌ . فَأُطْلِقَ اللَّفْظُ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الْمَفْعُولِ بِاسْمِ الْمَصْدَرِ ، كَقَوْلِهِمْ : نَسْجُ الْيَمِينِ : أَيْ مَنْسُوجُهُ . إذَا تَقَرَّرَ هَذَا ، فَاللَّفْظُ الِاصْطِلَاحِيُّ : نَوْعٌ لِلصَّوْتِ ، لِأَنَّهُ صَوْتٌ مَخْصُوصٌ . وَلِهَذَا أُخِذَ الصَّوْتُ فِي حَدِّ اللَّفْظِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ فِي حَدِّ الشَّيْءِ جِنْسُ ذَلِكَ الشَّيْءِ .
( وَالْقَوْلُ ) فِي اللُّغَةِ مُجَرَّدُ النُّطْقِ ، وَفِي الِاصْطِلَاحِ ( لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى ذِهْنِيٍّ ) لَمَّا كَانَ اللَّفْظُ أَعَمَّ مِنْ الْقَوْلِ لِشُمُولِهِ الْمُهْمَلَ ، وَالْمُسْتَعْمَلَ أُخْرِجَ الْمُهْمَلُ بِقَوْلِهِ " وُضِعَ لِمَعْنًى " وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْلِهِ " وُضِعَ لِمَعْنًى " عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ . أَحَدُهَا : مَا فِي الْمَتْنِ ، وَهُوَ الْمَعْنَى الذِّهْنِيُّ ، وَهُوَ مَا يَتَصَوَّرُهُ الْعَقْلُ ، سَوَاءً طَابَقَ مَا فِي الْخَارِجِ أَوْ لَا ، لِدَوَرَانِ الْأَلْفَاظِ مَعَ الْمَعَانِي الذِّهْنِيَّةِ وُجُودًا وَعَدَمًا . وَهَذَا الْقَوْلُ
[ ص: 32 ] اخْتَارَهُ
الرَّازِيّ وَأَتْبَاعُهُ ،
وَابْنُ حَمْدَانَ ،
وَابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ مِنْ أَصْحَابِنَا . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ وُضِعَ لِلْمَعْنَى الْخَارِجِيِّ ، أَيْ الْمَوْجُودِ فِي الْخَارِجِ . وَبِهِ قَطَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=11815أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ وُضِعَ لِلْمَعْنَى مِنْ حَيْثُ هُوَ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ كَوْنِهِ فِي الذِّهْنِ ، أَوْ فِي الْخَارِجِ . وَاخْتَارَهُ
السُّبْكِيُّ الْكَبِيرُ ، وَمَحَلُّ الْخِلَافُ فِي الِاسْمِ النَّكِرَةِ .
nindex.php?page=treesubj&link=20825_20826 ( وَالْوَضْعُ ) نَوْعَانِ . وَضْعٌ ( خَاصٌّ ، وَهُوَ جَعْلُ اللَّفْظِ دَلِيلًا عَلَى الْمَعْنَى ) الْمَوْضُوعِ لَهُ ، أَيْ جَعْلُ اللَّفْظِ مُتَهَيِّئًا لَأَنْ يُفِيدَ ذَلِكَ الْمَعْنَى عِنْدَ اسْتِعْمَالِ الْمُتَكَلِّمِ لَهُ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ . وَقَوْلُنَا ( وَلَوْ مَجَازًا ) لِيَشْمَلَ الْمَنْقُولَ مِنْ شَرْعِيٍّ وَعُرْفِيٍّ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ .
( وَ ) نَوْعٌ ( عَامٌّ ، وَهُوَ تَخْصِيصُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ . كَالْمَقَادِيرِ ) أَيْ كَجَعْلِ الْمَقَادِيرِ دَالَّةً عَلَى مُقَدَّرَاتِهَا مِنْ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ وَمَزْرُوعٍ وَغَيْرِهَا .
وَفِي كِلَا النَّوْعَيْنِ الْوَضْعُ : أَمْرٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْوَاضِعِ ( وَالِاسْتِعْمَالُ إطْلَاقُ اللَّفْظِ وَإِرَادَةُ الْمَعْنَى ) أَيْ إرَادَةُ مُسَمَّى اللَّفْظِ بِالْحُكْمِ ، وَهُوَ الْحَقِيقَةُ ، أَوْ غَيْرِ مُسَمَّاهُ لِعَلَاقَةٍ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ الْمَجَازُ ، وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الْمُتَكَلِّمِ ( وَالْحَمْلُ : اعْتِقَادُ السَّامِعِ مُرَادَ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ لَفْظِهِ ) أَوْ مَا اشْتَمَلَ عَلَى مُرَادِهِ . فَالْمُرَادُ : كَاعْتِقَادِ الْحَنْبَلِيِّ وَالْحَنَفِيِّ : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ بِلَفْظِ الْقُرْءِ : الْحَيْضَ ، وَالْمَالِكِيِّ وَالشَّافِعِيِّ : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ بِهِ : الطُّهْرَ . وَهَذَا مِنْ صِفَاتِ السَّامِعِ . فَالْوَضْعُ سَابِقٌ ، وَالْحَمْلُ لَاحِقٌ ، وَالِاسْتِعْمَالُ مُتَوَسِّطٌ .

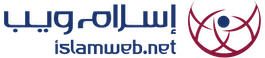
 المكتبة الإسلامية
المكتبة الإسلامية موسوعة التربية
موسوعة التربية كتاب الأمة
كتاب الأمة حول المكتبة
حول المكتبة قائمة الكتب
قائمة الكتب عرض موضوعي
عرض موضوعي تراجم الأعلام
تراجم الأعلام













 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات