(
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=146الذين آتيناهم الكتاب ) : هم علماء
اليهود والنصارى ، أو من آمن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من
اليهود ،
كابن سلام وغيره ، أو من آمن به مطلقا ، أقوال . والكتاب : التوراة ، أو الإنجيل ، أو مجموعهما ، أو القرآن . أقوال تنبني على من المراد بالذين آتيناهم ، ولفظ آتيناهم أبلغ من أوتوا ، لإسناد الإيتاء إلى الله تعالى ، معبرا عنه بنون العظمة ، وكذا ما يجيء من نحو هذا ، مرادا به الإكرام نحو : هدينا ، واجتبينا ، واصطفينا . قيل : ولأن أوتوا قد يستعمل فيما لم يكن له قبول ، وآتيناهم أكثر ما يستعمل فيما له قبول نحو : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=89الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة ) ، وإذا أريد بالكتاب أكثر من واحد ، فوحد ; لأنه صرف إلى المكتوب المعبر عنه بالمصدر .
( يعرفونه ) :
[ ص: 435 ] جملة في موضع الخبر عن المبتدأ الذي هو الذين آتيناهم ، وجوز أن يكون الذين مجرورا على أنه صفة للظالمين ، أو على أنه بدل من الظالمين ، أو على أنه بدل من (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=145الذين أوتوا الكتاب ) في الآية التي قبلها ، ومرفوعا على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي هم الذين ، ومنصوبا على إضمار ، أعني : وعلى هذه الأعاريب يكون قوله : ( يعرفونه ) ، جملة في موضع الحال ، إما من المفعول الأول في آتيناهم ، أو من الثاني الذي هو الكتاب ; لأن في يعرفونه ضميرين يعودان عليهما . والظاهر هو الإعراب الأول ، لاستقلال الكلام جملة منعقدة من مبتدأ وخبر ، ولظاهر انتهاء الكلام عند قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=145إنك إذا لمن الظالمين ) . والضمير المنصوب في يعرفونه عائد على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قاله
مجاهد وقتادة وغيرهما . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج ، ورجحه
التبريزي ، وبدأ به
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري فقال : يعرفونه معرفة جلية ، يميزون بينه وبين غيره بالوصف المعين المشخص . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري وغيره : واللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=14423للزمخشري ، وجاز الإضمار ، وإن لم يسبق له ذكر ; لأن الكلام يدل عليه ولا يلتبس على السامع ، ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار بأنه لشهرته وكونه علما معلوما بغير إعلام . انتهى . وأقول : ليس كما قالوه من أنه إضمار قبل الذكر : بل هذا من باب الالتفات ; لأنه قال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=144قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك ) ، ثم قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=145ولئن أتيت الذين ) إلى آخر الآية ، فهذه كلها ضمائر خطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم التفت عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة . وحكمة هذا الالتفات أنه لما فرغ من الإقبال عليه بالخطاب ، أقبل على الناس فقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=146الذين آتيناهم الكتاب ) واخترناهم لتحمل العلم والوحي ، يعرفون هذا الذي خاطبناه في الآي السابقة وأمرناه ونهيناه ، لا يشكون في معرفته ، ولا في صدق أخباره ، بما كلفناه من التكاليف التي منها نسخ
بيت المقدس بالكعبة ، لما في كتابهم من ذكره ونعته ، والنص عليه يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل . فقد اتضح بما ذكرناه أنه ليس من باب الإضمار قبل الذكر ، وأنه من باب الالتفات ، وتبينت حكمة الالتفات . ويؤيد كون الضمير لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما روي أن
عمر سأل
nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام - رضي الله عنهما - وقال : إن الله قد أنزل على نبيه : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=146nindex.php?page=treesubj&link=28973الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ) الآية ، فكيف هذه المعرفة ؟ فقال
عبد الله : يا
عمر ، لقد عرفته حين رأيته ، كما أعرف ابني ، ومعرفتي
بمحمد - صلى الله عليه وسلم - أشد من معرفتي بابني . فقال
عمر : وكيف ذلك ؟ فقال : أشهد أنه رسول الله حقا ، وقد نعته الله في كتابنا ، ولا أدري ما يصنع النساء . فقال
عمر : وفقك الله يا
ابن سلام فقد صدقت ، وقد روي هذا الأثر مختصرا بما يرادف بعض ألفاظه ويقاربها ، وفيه : فقبل
عمر رأسه . وإذا كان الضمير للرسول ، فقيل : المراد معرفة الوجه وتميزه ، لا معرفة حقيقة النسب . وقيل : المعنى يعرفون صدقه ونبوته . وقيل : الضمير عائد على الحق الذي هو التحول إلى الكعبة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقتادة أيضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج والربيع . وقيل : عائد على القرآن . وقيل : على العلم . وقيل : على كون البيت الحرام قبلة
إبراهيم ومن قبله من الأنبياء ، وهذه المعرفة مختصة بالعلماء ; لأنه قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=146الذين آتيناهم الكتاب ) ، فإن تعلقت المعرفة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فيكون حصولها بالرؤية والوصف ، أو بالقرآن ، فحصلت من تصديق كتابهم للقرآن ، وبنبوة
محمد - صلى الله عليه وسلم - وصفته ، أو بالقبلة ، أو التحويل ، فحصلت بخبر القرآن وخبر الرسول المؤيد بالخوارق .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=146كما يعرفون أبناءهم ) ، الكاف : في موضع نصب ، على أنها صفة لمصدر محذوف تقديره عرفانا مثل عرفانهم أبناءهم ، أو في موضع نصب على الحال من ضمير المعرفة المحذوف ، كان التقدير : يعرفونه معرفة مماثلة لمعرفة
[ ص: 436 ] أبنائهم . وظاهر هذا التشبيه أن المعرفة أريد بها معرفة الوجه والصورة ، وتشبيهها بمعرفة الأبناء يقوي ذلك ، ويقوي أن الضمير عائد على الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، حتى تكون المعرفتان تتعلقان بالمحسوس المشاهد ، وهو آكد في التشبيه من أن يكون التشبيه وقع بين معرفة متعلقها المعنى ، ومعرفة متعلقها المحسوس . وظاهر الأبناء الاختصاص بالذكور ، فيكونون قد خصوا بذلك ; لأنهم أكثر مباشرة ومعاشرة للآباء ، وألصق وأعلق بقلوب الآباء . ويحتمل أن يراد بالأبناء : الأولاد ، فيكون ذلك من باب التغليب . وكان التشبيه بمعرفة الأبناء آكد من التشبيه بالأنفس ; لأن الإنسان قد يمر عليه برهة من الزمان لا يعرف فيها نفسه ، بخلاف الأبناء ، فإنه لا يمر عليه زمان إلا وهو يعرف ابنه .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=146وإن فريقا منهم ليكتمون الحق ) : أي من الذين آتيناهم الكتاب ، وهم المصرون على الكفر والعناد ، من علماء
اليهود النصارى ، على أحسن التفاسير في الذين آتيناهم الكتاب ، وأبعد من ذهب إلى أنه أريد بهذا الفريق جهال
اليهود والنصارى ، الذين قيل فيهم : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=78ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ) ، للإخبار عن هذا الفريق أنهم يكتمون الحق وهم عالمون به ، ولوصف الأميين هناك بأنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني . والحق المكتوم هنا هو نعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قاله
قتادة ومجاهد ، والتوجه إلى الكعبة ، أو أن الكعبة هي القبلة ، أو أعم من ذلك ، فيندرج فيه كل حق .
( وهم يعلمون ) : جملة حالية ، أي عالمين بأنه حق . ويقرب أن يكون حالا مؤكدة ; لأن لفظ يكتمون الحق يدل على علمه به ; لأن الكتم هو إخفاء لما يعلم . وقيل : متعلق العلم هو ما على الكاتم من العقاب ، أي وهم يعلمون العقاب المرتب على كاتم الحق ، فيكون إذ ذاك حالا مبينة .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=147الحق من ربك ) : قرأ الجمهور : برفع الحق على أنه مبتدأ ، والخبر هو من ربك ، فيكون المجرور في موضع رفع ، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي هو الحق من ربك ، والضمير عائد على الحق المكتوم ، أي ما كتموه هو الحق من ربك ، ويكون المجرور في موضع الحال ، أو خبرا بعد خبر . وأبعد من ذهب إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره : الحق من ربك يعرفونه . والألف واللام في الحق للعهد ، وهو الحق الذي عليه الرسول ، أو الحق الذي كتموه ، أو للجنس على معنى : أن الحق هو من الله ، لا من غيره ، أي ما ثبت أنه حق فهو من الله ، كالذي عليه الرسول ، وما لم تثبت حقيقته ، فليس من الله ، كالباطل الذي عليه
أهل الكتاب . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : الحق بالنصب ، وأعرب بأن يكون بدلا من الحق المكتوم ، فيكون التقدير : يكتمون الحق من ربك ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري ; أو على أن يكون معمولا ليعلمون ، قاله
ابن عطية ، ويكون مما وقع فيه الظاهر موقع المضمر ، أي وهم يعلمونه كائنا من ربك ، وذلك سائغ حسن في أماكن التفخيم والتهويل ، كقوله :
لا أرى الموت يسبق الموت شيء
أي يسبقه شيء . وجوز
ابن عطية أن يكون منصوبا بفعل محذوف تقديره : الزم الحق من ربك ، ويدل عليه الخطاب بعده : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=147فلا تكونن من الممترين ) . والمراد بهذا الخطاب في المعنى هو الأمة . ودل الممترين على وجودهم ، ونهى أن يكون منهم ، والنهي عن كونه منهم أبلغ من النهي عن نفس الفعل . فقولك : لا تكن ظالما ، أبلغ من قولك : لا تظلم ; لأن لا تظلم نهي عن الالتباس بالظلم . وقولك : لا تكن ظالما نهي عن الكون بهذه الصفة . والنهي عن الكون على صفة ، أبلغ من النهي عن تلك الصفة ، إذ النهي عن الكون على صفة يدل بالوضع على عموم الأكوان المستقبلة على تلك الصفة ، ويلزم من ذلك عموم تلك الصفة . والنهي عن الصفة يدل بالوضع على عموم تلك الصفة . وفرق بين ما يدل على عموم ويستلزم عموما ، وبين ما يدل على عموم فقط ، فلذلك كان أبلغ ; ولذلك كثر النهي عن الكون . قال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=35فلا تكونن من الجاهلين "
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=95ولا [ ص: 437 ] تكونن من الذين كذبوا بآيات الله " " فلا تكن في مرية منه ) . والكينونة في الحقيقة ليست متعلق النهي . والمعنى : لا تظلم في كل أكوانك ، أي في كل فرد من أكوانك ، فلا يمر بك وقت يوجد فيه منك ظلم ، فتصير كان فيه نصا على سائر الأكوان ، بخلاف لا تظلم فإنه يستلزم الأكوان . وأكد النهي بنون التوكيد مبالغة في النهي ، وكانت المشددة لأنها أبلغ في التأكيد من المخففة . والمعنى : فلا تكونن من الذين يشكون في الحق ; لأن ما جاء من الله تعالى لا يمكن أن يقع فيه شك ولا جدال ، إذ هو الحق المحض الذي لا يمكن أن يلحق فيه ريب ولا شك .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=148ولكل وجهة هو موليها ) ، لما ذكر القبلة التي أمر المسلمون بالتوجه إليها ، وهي الكعبة ، وذكر من تصميم
أهل الكتاب على عدم اتباعها ، وأن كلا من طائفتي
اليهود والنصارى مصممة على عدم اتباع صاحبها ، أعلم أن ذلك هو بفعله ، وأنه هو المقدر ذلك ، وأنه هو موجه كل منهم إلى قبلته . ففي ذلك تنبيه على شكر الله ، إذ وفق المسلمين إلى اتباع ما أمر به من التوجه واختارهم لذلك . وقرأ الجمهور : " ولكل " : منونا ، " وجهة " : مرفوعا ، هو موليها : بكسر اللام اسم فاعل . وقرأ
ابن عامر : هو مولاها ، بفتح اللام اسم مفعول ، وهي قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وقرأ قوم شاذا : ولكل وجهة ، بخفض اللام من " كل " من غير تنوين ، وجهة : بالخفض منونا على الإضافة ، والتنوين في كل تنوين عوض من الإضافة ، وذلك المضاف إليه " كل " المحذوف اختلف في تقديره . فقيل : المعنى : ولكل طائفة من أهل الأديان . وقيل : المعنى : ولكل أهل صقع من المسلمين وجهة من أهل سائر الآفاق إلى جهة الكعبة ، وراءها وقدامها ، ويمينها وشمالها ، ليست جهة من جهاتها بأولى أن تكون قبلة من غيرها . وقيل : المعنى : ولكل نبي قبلة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وقيل : المعنى : ولكل ملك ورسول صاحب شريعة جهة قبلة ، فقبلة المقربين العرش ، وقبلة الروحانيين الكرسي ، وقبلة الكروبيين البيت المعمور ، وقبلة الأنبياء قبلك
بيت المقدس ، وقبلتك الكعبة ، وقد اندرج في هذا الذي ذكرناه أن المراد بوجهه : قبلة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهي قراءة
أبي ، قرأ : ولكل قبلة . وقرأ
عبد الله : ولكل جعلنا قبلة . وقال
الحسن : وجهة : طريقة ، كما قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=48لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) ، أي لكل نبي طريقة . وقال
قتادة : وجهة : أي صلاة يصلونها ، وهو من قوله : " هو موليها " عائد على " كل " على لفظه ، لا على معناه ، أي هو مستقبلها وموجه إليها صلاته التي يتقرب بها ، والمفعول الثاني لموليها محذوف لفهم المعنى ، أي هو موليها وجهه أو نفسه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعطاء والربيع ، ويؤيد أن " هو " عائد على كل قراءة من قرأ : " هو مولاها " . وقيل : هو عائد على الله تعالى ، قاله
الأخفش nindex.php?page=showalam&ids=14416والزجاج ، أي الله موليها إياه ، اتبعها من اتبعها وتركها من تركها . فمعنى هو موليها على هذا التقدير : شارعها ومكلفهم بها . والجملة من الابتداء والخبر في موضع الصفة لوجهة . وأما قراءة من قرأ : " ولكل وجهة " على الإضافة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير : هي خطأ ، ولا ينبغي أن يقدم على الحكم في ذلك بالخطأ ، لا سيما وهي معزوة إلى
ابن عامر ، أحد القراء السبعة ، وقد وجهت هذه القراءة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : المعنى : ولكل وجهة الله موليها ، فزيدت اللام لتقدم المفعول ،
[ ص: 438 ] كقولك : لزيد ضربت ، ولزيد أبوه ضاربه . انتهى كلامه ، وهذا فاسد ; لأن العامل إذا تعدى لضمير الاسم لم يتعد إلى ظاهره المجرور باللام . لا يجوز أن يقول : لزيد ضربته ، ولا : لزيد أنا ضاربه . وعليه أن الفعل إذا تعدى للضمير بغير واسطة كان قويا ، واللام إنما تدخل على الظاهر إذا تقدم ليقويه لضعف وصوله إليه متقدما ، ولا يمكن أن يكون العامل قويا ضعيفا في حالة واحدة ، ولأنه يلزم من ذلك أن يكون المتعدي إلى واحد يتعدى إلى اثنين ، ولذلك تأول النحويون قوله هذا :
سراقة للقرآن يدرسه
وليس نظير ما مثل به من قوله : لزيد ضربت ، أي زيدا ضربت ; لأن ضربت في هذا المثال لم يعمل في ضمير زيد ، ولا يجوز أن يقدر عامل في : " لكل وجهة " يفسره قوله : " موليها " ، كتقديرنا زيدا أنا ضاربه ، أي أضرب زيدا أنا ضاربه ، فتكون المسألة من باب الاشتغال ; لأن المشتغل عنه لا يجوز أن يجر بحرف الجر . تقول : زيدا مررت به ، أي لابست زيدا ، ولا يجوز : بزيد مررت به ، فيكون التقدير : مررت بزيد مررت به ، بل كل فعل يتعدى بحرف الجر ، إذا تسلط على ضمير اسم سابق في باب الاشتغال ، فلا يجوز في ذلك الاسم السابق أن يجر بحرف جر ، ويقدر ذلك الفعل ليتعلق به حرف الجر ، بل إذا أردت الاشتغال نصبته ، هكذا جرى كلام العرب . قال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=31والظالمين أعد لهم عذابا أليما ) . وقال الشاعر :
أثعلبة الفوارس أم رباحا عدلت بهم طهية والخشابا
وأما تمثيله : لزيد أبوه ضاربه ، فتركيب غير عربي . فإن قلت : لم لا تتوجه هذه القراءة على أن " لكل وجهة " في موضع المفعول الثاني " لموليها " ، والمفعول الأول هو المضاف إليه اسم الفاعل الذي هو مول ، وهو الهاء ، وتكون عائدة على أهل القبلات والطوائف ، وأنث على معنى الطوائف ، وقد تقدم ذكرهم ، ويكون التقدير : وكل وجهة الله مولي الطوائف أصحاب القبلات ؟ فالجواب : أنه منع هذا التقدير نص النحويين على أن المتعدي إلى واحد هو الذي يجوز أن تدخل اللام على مفعوله إذا تقدم . أما ما يتعدى إلى اثنين ، فلا يجوز أن يدخل على واحد منهما اللام إذا تقدم ، ولا إذا تأخر . وكذلك ما يتعدى إلى ثلاثة . ومول هنا اسم فاعل من فعل يتعدى إلى اثنين ، فلذلك لا يجوز هذا التقدير . وقال
ابن عطية ، في توجيه هذه القراءة : أي فاستبقوا الخيرات لكل وجهة ولاكموها ، ولا تعترضوا فيما أمركم بين هذه وهذه ، أي إنما عليكم الطاعة في الجميع . وقدم قوله : " لكل وجهة " على الأمر في قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=148فاستبقوا الخيرات " ; للاهتمام بالوجهة ، كما تقدم المفعول . انتهى كلام
ابن عطية ، وهو
[ ص: 439 ] توجيه لا بأس به .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=148فاستبقوا الخيرات ) : هذا أمر بالبدار إلى فعل الخير والعمل الصالح . وناسب هذا أن من جعل الله له شريعة ، أو قبلة ، أو صلاة ، فينبغي الاهتمام بالمسارعة إليها . قال
قتادة : الاستباق في أمر الكعبة رغما لليهود بالمخالفة . وقال
ابن زيد : معناه : سارعوا إلى الأعمال الصالحة من التوجه إلى القبلة وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : ويجوز أن يكون المعنى : فاستبقوا الفاضلات من الجهات ، وهي الجهات المسامتة للكعبة ، وإن اختلفت . وذكرنا أن استبق بمعنى : تسابق ، فهو يدل على الاشتراك . (
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=17إنا ذهبنا نستبق ) ، أي نتسابق ، كما تقول . تضاربوا . واستبق لا يتعدى ; لأن تسابق لا يتعدى ، وذلك أن الفعل المتعدي ، إذا بنيت من لفظ معناه : تفاعل للاشتراك ، صار لازما ، تقول : ضربت زيدا ، ثم تقول : تضاربنا ، فلذلك قيل : إن " إلى " هنا محذوفة ، التقدير : فاستبقوا إلى الخيرات . قال
الراعي :
ثنائي عليكم آل حرب ومن يمل سواكم فإني مهتد غير مائل
يريد ومن يمل سواكم (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=148أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا ) : هذه جملة تتضمن وعظا وتحذيرا وإظهارا لقدرته ، ومعنى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=148يأت بكم الله جميعا ) : أي يبعثكم ويحشركم للثواب والعقاب ، فأنتم لا تعجزونه ، وافقتم أم خالفتم ، ولذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يعني يوم القيامة . وقيل : المعنى : أينما تكونوا من الجهات المختلفة يأت بكم الله جميعا ، أي يجمعكم ويجعل صلاتكم كلها إلى جهة واحدة ، وكأنكم تصلون حاضري المسجد الحرام ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري . (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=148إن الله على كل شيء قدير ) تقدم شرح هذه الجملة ، وسيقت بعد الجملة الشرطية المتضمنة للبعث والجزاء ، أي لا يستبعد إتيان الله تعالى بالأشلاء المتمزقة في الجهات المتعددة المتفرقة ، فإن قدرة الله تتعلق بالممكنات ، وهذا منها . وقد تقدم لنا أن مثل هذه الجملة المصدرة بأن تجيء كالعلة لما قبلها ، فكان المعنى : إتيان الله بكم جميعا لقدرته على ذلك .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=146الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ) : هُمْ عُلَمَاءُ
الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، أَوْ مَنْ آمَنَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ
الْيَهُودِ ،
كَابْنِ سَلَامٍ وَغَيْرِهِ ، أَوْ مَنْ آمَنَ بِهِ مُطْلَقًا ، أَقْوَالٌ . وَالْكِتَابُ : التَّوْرَاةُ ، أَوِ الْإِنْجِيلُ ، أَوْ مَجْمُوعُهُمَا ، أَوِ الْقُرْآنُ . أَقْوَالٌ تَنْبَنِي عَلَى مَنِ الْمُرَادِ بِالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ ، وَلَفْظُ آتَيْنَاهُمْ أَبْلَغُ مِنْ أُوتُوا ، لِإِسْنَادِ الْإِيتَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، مُعَبِّرًا عَنْهُ بِنُونِ الْعَظَمَةِ ، وَكَذَا مَا يَجِيءُ مِنْ نَحْوِ هَذَا ، مُرَادًا بِهِ الْإِكْرَامُ نَحْوُ : هَدَيْنَا ، وَاجْتَبَيْنَا ، وَاصْطَفَيْنَا . قِيلَ : وَلِأَنَّ أُوتُوا قَدْ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبُولٌ ، وَآتَيْنَاهُمْ أَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِيمَا لَهُ قَبُولٌ نَحْوُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=89الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ) ، وَإِذًا أُرِيدَ بِالْكِتَابِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ ، فَوَحَّدَ ; لِأَنَّهُ صُرِفَ إِلَى الْمَكْتُوبِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِالْمَصْدَرِ .
( يَعْرِفُونَهُ ) :
[ ص: 435 ] جُمْلَةٌ فِي مَوْضِعِ الْخَبَرِ عَنِ الْمُبْتَدَأِ الَّذِي هُوَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ ، وَجُوِّزَ أَنْ يَكُونَ الَّذِينَ مَجْرُورًا عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِلظَّالِمِينَ ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِنَ الظَّالِمِينَ ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=145الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) فِي الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ، وَمَرْفُوعًا عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ، أَيْ هُمُ الَّذِينَ ، وَمَنْصُوبًا عَلَى إِضْمَارِ ، أَعْنِي : وَعَلَى هَذِهِ الْأَعَارِيبِ يَكُونُ قَوْلُهُ : ( يَعْرِفُونَهُ ) ، جُمْلَةً فِي مَوْضِعِ الْحَالِ ، إِمَّا مِنَ الْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ فِي آتَيْنَاهُمْ ، أَوْ مِنَ الثَّانِي الَّذِي هُوَ الْكِتَابُ ; لِأَنَّ فِي يَعْرِفُونَهُ ضَمِيرَيْنِ يَعُودَانِ عَلَيْهِمَا . وَالظَّاهِرُ هُوَ الْإِعْرَابُ الْأَوَّلُ ، لِاسْتِقْلَالِ الْكَلَامِ جُمْلَةً مُنْعَقِدَةً مِنْ مُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ ، وَلِظَاهِرِ انْتِهَاءِ الْكَلَامِ عِنْدَ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=145إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ) . وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ فِي يَعْرِفُونَهُ عَائِدٌ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَهُ
مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُهُمَا . وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَاخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ ، وَرَجَّحَهُ
التَّبْرِيزِيُّ ، وَبَدَأَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ فَقَالَ : يَعْرِفُونَهُ مَعْرِفَةً جَلِيَّةً ، يُمَيِّزُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِالْوَصْفِ الْمُعَيِّنِ الْمُشَخِّصِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ وَغَيْرُهُ : وَاللَّفْظُ
nindex.php?page=showalam&ids=14423لِلزَّمَخْشَرِيِّ ، وَجَازَ الْإِضْمَارُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ ذِكْرٌ ; لِأَنَّ الْكَلَامَ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَا يَلْتَبِسُ عَلَى السَّامِعِ ، وَمِثْلُ هَذَا الْإِضْمَارِ فِيهِ تَفْخِيمٌ وَإِشْعَارٌ بِأَنَّهُ لِشُهْرَتِهِ وَكَوْنِهِ عِلْمًا مَعْلُومًا بِغَيْرِ إِعْلَامٍ . انْتَهَى . وَأَقُولُ : لَيْسَ كَمَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّهُ إِضْمَارٌ قَبْلَ الذِّكْرِ : بَلْ هَذَا مِنْ بَابِ الِالْتِفَاتِ ; لِأَنَّهُ قَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=144قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ ) ، ثُمَّ قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=145وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ ) إِلَى آخَرِ الْآيَةِ ، فَهَذِهِ كُلُّهَا ضَمَائِرُ خِطَابٍ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ ضَمِيرِ الْخِطَابِ إِلَى ضَمِيرِ الْغَيْبَةِ . وَحِكْمَةٌ هَذَا الِالْتِفَاتِ أَنَّهُ لَمَّا فَرَغَ مِنَ الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ بِالْخِطَابِ ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=146الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ) وَاخْتَرْنَاهُمْ لِتَحَمُّلِ الْعِلْمِ وَالْوَحْيِ ، يَعْرِفُونَ هَذَا الَّذِي خَاطَبْنَاهُ فِي الْآيِ السَّابِقَةِ وَأَمَرْنَاهُ وَنَهَيْنَاهُ ، لَا يَشُكُّونَ فِي مَعْرِفَتِهِ ، وَلَا فِي صِدْقِ أَخْبَارِهِ ، بِمَا كَلَّفْنَاهُ مِنَ التَّكَالِيفِ الَّتِي مِنْهَا نُسِخَ
بَيْتُ الْمَقْدِسِ بِالْكَعْبَةِ ، لِمَا فِي كِتَابِهِمْ مِنْ ذِكْرِهِ وَنَعْتِهِ ، وَالنَّصِّ عَلَيْهِ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ . فَقَدِ اتَّضَحَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِضْمَارِ قَبْلَ الذِّكْرِ ، وَأَنَّهُ مِنْ بَابِ الِالْتِفَاتِ ، وَتَبَيَّنَتْ حِكْمَةُ الِالْتِفَاتِ . وَيُؤَيِّدُ كَوْنَ الضَّمِيرِ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا رُوِيَ أَنَّ
عُمَرَ سَأَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=106عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=146nindex.php?page=treesubj&link=28973الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ ) الْآيَةَ ، فَكَيْفَ هَذِهِ الْمَعْرِفَةُ ؟ فَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ : يَا
عُمَرُ ، لَقَدْ عَرَفْتُهُ حِينَ رَأَيْتُهُ ، كَمَا أَعْرِفُ ابْنِي ، وَمَعْرِفَتِي
بِمُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَشَدُّ مِنْ مَعْرِفَتِي بِابْنِي . فَقَالَ
عُمَرُ : وَكَيْفَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا ، وَقَدْ نَعَتَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِنَا ، وَلَا أَدْرِي مَا يَصْنَعُ النِّسَاءُ . فَقَالَ
عُمَرُ : وَفَّقَكَ اللَّهُ يَا
ابْنَ سَلَامٍ فَقَدْ صَدَقْتَ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْأَثَرُ مُخْتَصَرًا بِمَا يُرَادِفُ بَعْضَ أَلْفَاظِهِ وَيُقَارِبُهَا ، وَفِيهِ : فَقَبَّلَ
عُمَرُ رَأَسَهُ . وَإِذَا كَانَ الضَّمِيرُ لِلرَّسُولِ ، فَقِيلَ : الْمُرَادُ مَعْرِفَةُ الْوَجْهِ وَتَمَيُّزِهِ ، لَا مَعْرِفَةُ حَقِيقَةِ النَّسَبِ . وَقِيلَ : الْمَعْنَى يَعْرِفُونَ صِدْقَهُ وَنُبُوَّتَهُ . وَقِيلَ : الضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْحَقِّ الَّذِي هُوَ التَّحَوُّلُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةُ أَيْضًا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وَابْنُ جُرَيْجٍ وَالرَّبِيعُ . وَقِيلَ : عَائِدٌ عَلَى الْقُرْآنِ . وَقِيلَ : عَلَى الْعِلْمِ . وَقِيلَ : عَلَى كَوْنِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَةَ
إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَهَذِهِ الْمَعْرِفَةُ مُخْتَصَّةٌ بِالْعُلَمَاءِ ; لِأَنَّهُ قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=146الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ) ، فَإِنْ تَعَلَّقَتِ الْمَعْرِفَةُ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَيَكُونُ حُصُولُهَا بِالرُّؤْيَةِ وَالْوَصْفِ ، أَوْ بِالْقُرْآنِ ، فَحَصَلَتْ مِنْ تَصْدِيقِ كِتَابِهِمْ لِلْقُرْآنِ ، وَبِنُبُوَّةِ
مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَفَتِهِ ، أَوْ بِالْقِبْلَةِ ، أَوِ التَّحْوِيلِ ، فَحَصَلَتْ بِخَبَرِ الْقُرْآنِ وَخَبَرِ الرَّسُولِ الْمُؤَيَّدِ بِالْخَوَارِقِ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=146كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ) ، الْكَافُ : فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ ، عَلَى أَنَّهَا صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ عِرْفَانًا مِثْلَ عِرْفَانِهِمْ أَبْنَاءَهُمْ ، أَوْ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ مِنْ ضَمِيرِ الْمَعْرِفَةِ الْمَحْذُوفِ ، كَانَ التَّقْدِيرُ : يَعْرِفُونَهُ مَعْرِفَةً مُمَاثِلَةً لِمَعْرِفَةِ
[ ص: 436 ] أَبْنَائِهِمْ . وَظَاهِرُ هَذَا التَّشْبِيهِ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ أُرِيدَ بِهَا مَعْرِفَةُ الْوَجْهِ وَالصُّورَةِ ، وَتَشْبِيهُهَا بِمَعْرِفَةِ الْأَبْنَاءِ يُقَوِّي ذَلِكَ ، وَيُقَوِّي أَنَّ الضَّمِيرَ عَائِدٌ عَلَى الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، حَتَّى تَكُونَ الْمَعْرِفَتَانِ تَتَعَلَّقَانِ بِالْمَحْسُوسِ الْمُشَاهَدِ ، وَهُوَ آكَدُ فِي التَّشْبِيهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ التَّشْبِيهُ وَقَعَ بَيْنَ مَعْرِفَةٍ مُتَعَلِّقُهَا الْمَعْنَى ، وَمَعْرِفَةٍ مُتَعَلِّقُهَا الْمَحْسُوسُ . وَظَاهِرُ الْأَبْنَاءِ الِاخْتِصَاصُ بِالذُّكُورِ ، فَيَكُونُونَ قَدْ خُصُّوا بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُمْ أَكْثَرُ مُبَاشَرَةً وَمُعَاشَرَةً لِلْآبَاءِ ، وَأَلْصَقُ وَأَعْلَقُ بِقُلُوبِ الْآبَاءِ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِالْأَبْنَاءِ : الْأَوْلَادُ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّغْلِيبِ . وَكَانَ التَّشْبِيهُ بِمَعْرِفَةِ الْأَبْنَاءِ آكَدَ مِنَ التَّشْبِيهِ بِالْأَنْفُسِ ; لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَمُرُّ عَلَيْهِ بُرْهَةٌ مِنَ الزَّمَانِ لَا يَعْرِفُ فِيهَا نَفْسَهُ ، بِخِلَافِ الْأَبْنَاءِ ، فَإِنَّهُ لَا يَمُرُّ عَلَيْهِ زَمَانٌ إِلَّا وَهُوَ يَعْرِفُ ابْنَهُ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=146وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ ) : أَيْ مِنَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ، وَهُمُ الْمُصِرُّونَ عَلَى الْكُفْرِ وَالْعِنَادِ ، مِنْ عُلَمَاءِ
الْيَهُودِ النَّصَارَى ، عَلَى أَحْسَنِ التَّفَاسِيرِ فِي الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ، وَأَبْعَدَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِهَذَا الْفَرِيقِ جُهَّالُ
الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، الَّذِينَ قِيلَ فِيهِمْ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=78وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ ) ، لِلْإِخْبَارِ عَنْ هَذَا الْفَرِيقِ أَنَّهُمْ يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ عَالِمُونَ بِهِ ، وَلِوَصْفِ الْأُمِّيِّينَ هُنَاكَ بِأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ . وَالْحَقُّ الْمَكْتُومُ هُنَا هُوَ نَعْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَهُ
قَتَادَةُ وَمُجَاهِدٌ ، وَالتَّوَجُّهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، أَوْ أَنَّ الْكَعْبَةَ هِيَ الْقِبْلَةُ ، أَوْ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ ، فَيَنْدَرِجُ فِيهِ كُلُّ حَقٍّ .
( وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) : جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ ، أَيْ عَالِمَيْنِ بِأَنَّهُ حَقٌّ . وَيَقْرُبُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مُؤَكِّدَةً ; لِأَنَّ لَفْظَ يَكْتُمُونَ الْحَقَّ يَدُلُّ عَلَى عِلْمِهِ بِهِ ; لِأَنَّ الْكَتْمَ هُوَ إِخْفَاءٌ لِمَا يُعْلَمُ . وَقِيلَ : مُتَعَلِّقُ الْعِلْمِ هُوَ مَا عَلَى الْكَاتِمِ مِنَ الْعِقَابِ ، أَيْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْعِقَابَ الْمُرَتَّبَ عَلَى كَاتِمِ الْحَقِّ ، فَيَكُونُ إِذْ ذَاكَ حَالًا مُبَيِّنَةً .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=147الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ) : قَرَأَ الْجُمْهُورُ : بِرَفْعِ الْحَقِّ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ ، وَالْخَبَرُ هُوَ مِنْ رَبِّكَ ، فَيَكُونُ الْمَجْرُورُ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ، أَيْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ، وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْحَقِّ الْمَكْتُومِ ، أَيْ مَا كَتَمُوهُ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ، وَيَكُونُ الْمَجْرُورُ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ ، أَوْ خَبَرًا بَعْدَ خَبَرٍ . وَأَبْعَدَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ : الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ يَعْرِفُونَهُ . وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ فِي الْحَقِّ لِلْعَهْدِ ، وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي عَلَيْهِ الرَّسُولُ ، أَوِ الْحَقُّ الَّذِي كَتَمُوهُ ، أَوْ لِلْجِنْسِ عَلَى مَعْنَى : أَنَّ الْحَقَّ هُوَ مِنَ اللَّهِ ، لَا مِنْ غَيْرِهِ ، أَيْ مَا ثَبَتَ أَنَّهُ حَقٌّ فَهُوَ مِنَ اللَّهِ ، كَالَّذِي عَلَيْهِ الرَّسُولُ ، وَمَا لَمْ تَثْبُتْ حَقِيقَتُهُ ، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ ، كَالْبَاطِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
أَهْلُ الْكِتَابِ . وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : الْحَقَّ بِالنَّصْبِ ، وَأُعْرِبَ بِأَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنَ الْحَقِّ الْمَكْتُومِ ، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ : يَكْتُمُونَ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ ; أَوْ عَلَى أَنْ يَكُونَ مَعْمُولًا لِيَعْلَمُونِ ، قَالَهُ
ابْنُ عَطِيَّةَ ، وَيَكُونُ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ الظَّاهِرُ مَوْقِعَ الْمُضْمَرِ ، أَيْ وَهُمْ يَعْلَمُونَهُ كَائِنًا مِنْ رَبِّكَ ، وَذَلِكَ سَائِغٌ حَسَنٌ فِي أَمَاكِنِ التَّفْخِيمِ وَالتَّهْوِيلِ ، كَقَوْلِهِ :
لَا أَرَى الْمَوْتَ يَسْبِقُ الْمَوْتَ شَيْءٌ
أَيْ يَسْبِقُهُ شَيْءٌ . وَجَوَّزَ
ابْنُ عَطِيَّةَ أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ : الْزَمِ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْخِطَابُ بَعْدَهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=147فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ) . وَالْمُرَادُ بِهَذَا الْخِطَابِ فِي الْمَعْنَى هُوَ الْأُمَّةُ . وَدَلَّ الْمُمْتَرِينَ عَلَى وُجُودِهِمْ ، وَنَهَى أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ ، وَالنَّهْيُ عَنْ كَوْنِهِ مِنْهُمْ أَبْلَغَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ نَفْسِ الْفِعْلِ . فَقَوْلُكَ : لَا تَكُنْ ظَالِمًا ، أَبْلَغُ مِنْ قَوْلِكَ : لَا تَظْلِمْ ; لِأَنَّ لَا تَظْلِمْ نَهْيٌ عَنِ الِالْتِبَاسِ بِالظُّلْمِ . وَقَوْلُكُ : لَا تَكُنْ ظَالِمًا نَهْيٌ عَنِ الْكَوْنِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ . وَالنَّهْيُ عَنِ الْكَوْنِ عَلَى صِفَةٍ ، أَبْلَغُ مِنَ النَّهْيِ عَنْ تِلْكَ الصِّفَةِ ، إِذِ النَّهْيُ عَنِ الْكَوْنِ عَلَى صِفَةٍ يَدُلُّ بِالْوَضْعِ عَلَى عُمُومِ الْأَكْوَانِ الْمُسْتَقْبِلَةِ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ ، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ عُمُومُ تِلْكَ الصِّفَةِ . وَالنَّهْيُ عَنِ الصِّفَةِ يَدُلُّ بِالْوَضْعِ عَلَى عُمُومِ تِلْكَ الصِّفَةِ . وَفَرْقٌ بَيْنَ مَا يَدُلُّ عَلَى عُمُومٍ وَيَسْتَلْزِمُ عُمُومًا ، وَبَيْنَ مَا يَدُلُّ عَلَى عُمُومٍ فَقَطْ ، فَلِذَلِكَ كَانَ أَبْلَغَ ; وَلِذَلِكَ كَثُرَ النَّهْيُ عَنِ الْكَوْنِ . قَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=35فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ "
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=95وَلَا [ ص: 437 ] تَكُونُنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ " " فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ ) . وَالْكَيْنُونَةُ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَتْ مُتَعَلِّقَ النَّهْيِ . وَالْمَعْنَى : لَا تَظْلِمْ فِي كُلِّ أَكْوَانِكَ ، أَيْ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَكْوَانِكَ ، فَلَا يَمُرُّ بِكَ وَقْتٌ يُوجَدُ فِيهِ مِنْكَ ظُلْمٌ ، فَتَصِيرُ كَانَ فِيهِ نَصًّا عَلَى سَائِرِ الْأَكْوَانِ ، بِخِلَافِ لَا تَظْلِمْ فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ الْأَكْوَانَ . وَأَكَّدَ النَّهْيَ بِنُونِ التَّوْكِيدِ مُبَالَغَةً فِي النَّهْيِ ، وَكَانَتِ الْمُشَدَّدَةُ لِأَنَّهَا أَبْلَغُ فِي التَّأْكِيدِ مِنَ الْمُخَفَّفَةِ . وَالْمَعْنَى : فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ يَشُكُّونَ فِي الْحَقِّ ; لِأَنَّ مَا جَاءَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ شَكٌّ وَلَا جِدَالٌ ، إِذْ هُوَ الْحَقُّ الْمَحْضُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ أَنْ يَلْحَقَ فِيهِ رَيْبَ وَلَا شَكَّ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=148وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ) ، لَمَّا ذَكَرَ الْقِبْلَةَ الَّتِي أُمِرَ الْمُسْلِمُونَ بِالتَّوَجُّهِ إِلَيْهَا ، وَهِيَ الْكَعْبَةُ ، وَذَكَرَ مِنْ تَصْمِيمِ
أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى عَدَمِ اتِّبَاعِهَا ، وَأَنَّ كُلًّا مِنْ طَائِفَتِي
الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مُصَمِّمَةٌ عَلَى عَدَمِ اتِّبَاعِ صَاحِبِهَا ، أَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ بِفِعْلِهِ ، وَأَنَّهُ هُوَ الْمُقَدِّرُ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ هُوَ مُوَجِّهُ كُلٍّ مِنْهُمْ إِلَى قِبْلَتِهِ . فَفِي ذَلِكَ تَنْبِيهٌ عَلَى شُكْرِ اللَّهِ ، إِذْ وَفَّقَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى اتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ مِنَ التَّوَجُّهِ وَاخْتَارَهُمْ لِذَلِكَ . وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ : " وَلِكُلٍّ " : مَنَّوْنًا ، " وِجْهَةٌ " : مَرْفُوعًا ، هُوَ مُوَلِّيهَا : بِكَسْرِ اللَّامِ اسْمُ فَاعِلٍ . وَقَرَأَ
ابْنُ عَامِرٍ : هُوَ مُوَلَّاهَا ، بِفَتْحِ اللَّامِ اسْمُ مَفْعُولٍ ، وَهِيَ قِرَاءَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . وَقَرَأَ قَوْمٌ شَاذًّا : وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ ، بِخَفْضِ اللَّامِ مِنْ " كُلِّ " مِنْ غَيْرِ تَنْوِينٍ ، وِجِهَةٍ : بِالْخَفْضِ مَنَّوْنًا عَلَى الْإِضَافَةِ ، وَالتَّنْوِينُ فِي كُلٍّ تَنْوِينُ عِوَضٍ مِنَ الْإِضَافَةِ ، وَذَلِكَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ " كُلٍّ " الْمَحْذُوفُ اخْتُلِفَ فِي تَقْدِيرِهِ . فَقِيلَ : الْمَعْنَى : وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ . وَقِيلَ : الْمَعْنَى : وَلِكُلِّ أَهْلِ صَقْعٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وِجْهَةٌ مِنْ أَهْلِ سَائِرِ الْآفَاقِ إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ ، وَرَاءَهَا وَقُدَّامَهَا ، وَيَمِينَهَا وَشِمَالَهَا ، لَيْسَتْ جِهَةٌ مِنْ جِهَاتِهَا بِأَوْلَى أَنْ تَكُونَ قِبْلَةً مِنْ غَيْرِهَا . وَقِيلَ : الْمَعْنَى : وَلِكُلِّ نَبِيٍّ قِبْلَةٌ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ . وَقِيلَ : الْمَعْنَى : وَلِكُلِّ مَلَكٍ وَرَسُولٍ صَاحِبِ شَرِيعَةٍ جِهَةُ قِبْلَةٍ ، فَقِبْلَةُ الْمُقَرَّبِينَ الْعَرْشُ ، وَقِبْلَةُ الرُّوحَانِيِّينَ الْكُرْسِيُّ ، وَقِبْلَةُ الْكُرُوبِيِّينَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ، وَقِبْلَةُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ
بَيْتُ الْمَقْدِسِ ، وَقِبْلَتُكَ الْكَعْبَةُ ، وَقَدِ انْدَرَجَ فِي هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِوَجْهِهِ : قِبْلَةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهِيَ قِرَاءَةُ
أُبَيٍّ ، قَرَأَ : وَلِكُلٍّ قِبْلَةٌ . وَقَرَأَ
عَبْدُ اللَّهِ : وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا قِبْلَةً . وَقَالَ
الْحَسَنُ : وِجْهَةً : طَرِيقَةً ، كَمَا قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=48لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ) ، أَيْ لِكُلِّ نَبِيٍّ طَرِيقَةٌ . وَقَالَ
قَتَادَةُ : وِجْهَةً : أَيْ صَلَاةً يُصَلُّونَهَا ، وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِ : " هُوَ مُوَلِّيهَا " عَائِدٌ عَلَى " كُلٍّ " عَلَى لَفْظِهِ ، لَا عَلَى مَعْنَاهُ ، أَيْ هُوَ مُسْتَقْبِلُهَا وَمُوَجِّهٌ إِلَيْهَا صَلَاتَهُ الَّتِي يَتَقَرَّبُ بِهَا ، وَالْمَفْعُولُ الثَّانِي لِمُوَلِّيهَا مَحْذُوفٌ لِفَهْمِ الْمَعْنَى ، أَيْ هُوَ مُوَلِّيهَا وَجْهَهُ أَوْ نَفْسَهُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ وَالرَّبِيعُ ، وَيُؤَيِّدُ أَنَّ " هُوَ " عَائِدٌ عَلَى كُلِّ قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ : " هُوَ مُوَلَّاهَا " . وَقِيلَ : هُوَ عَائِدٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ، قَالَهُ
الْأَخْفَشُ nindex.php?page=showalam&ids=14416وَالزَّجَّاجُ ، أَيِ اللَّهُ مُوَلِّيهَا إِيَّاهُ ، اتَّبَعَهَا مَنِ اتَّبَعَهَا وَتَرَكَهَا مَنْ تَرَكَهَا . فَمَعْنَى هُوَ مُوَلِّيهَا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ : شَارِعُهَا وَمُكَلِّفُهُمْ بِهَا . وَالْجُمْلَةُ مِنَ الِابْتِدَاءِ وَالْخَبَرِ فِي مَوْضِعِ الصِّفَةِ لِوِجْهَةٍ . وَأَمَّا قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ : " وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ " عَلَى الْإِضَافَةِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ : هِيَ خَطَأٌ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْدَمَ عَلَى الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ بِالْخَطَأِ ، لَا سِيَّمَا وَهِيَ مَعْزُوَّةٌ إِلَى
ابْنِ عَامِرٍ ، أَحَدِ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ ، وَقَدْ وُجِّهَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : الْمَعْنَى : وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ اللَّهُ مُوَلِّيهَا ، فَزِيدَتِ اللَّامُ لِتَقَدُّمِ الْمَفْعُولِ ،
[ ص: 438 ] كَقَوْلِكَ : لِزَيْدٍ ضَرَبْتُ ، وَلِزَيْدٍ أَبُوهُ ضَارِبُهُ . انْتَهَى كَلَامُهُ ، وَهَذَا فَاسِدٌ ; لِأَنَّ الْعَامِلَ إِذَا تَعَدَّى لِضَمِيرِ الِاسْمِ لَمْ يَتَعَدَّ إِلَى ظَاهِرِهِ الْمَجْرُورِ بِاللَّامِ . لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ : لِزَيْدٍ ضَرَبْتُهُ ، وَلَا : لِزَيْدٍ أَنَا ضَارِبُهُ . وَعَلَيْهِ أَنَّ الْفِعْلَ إِذَا تَعَدَّى لِلضَّمِيرِ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ كَانَ قَوِيًّا ، وَاللَّامُ إِنَّمَا تَدْخُلُ عَلَى الظَّاهِرِ إِذَا تَقَدَّمَ لِيُقَوِّيَهُ لِضَعْفِ وُصُولِهِ إِلَيْهِ مُتَقَدِّمًا ، وَلَا يُمْكِنَ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ قَوِيًّا ضَعِيفًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمُتَعَدِّي إِلَى وَاحِدٍ يَتَعَدَّى إِلَى اثْنَيْنِ ، وَلِذَلِكَ تَأَوَّلَ النَّحْوِيُّونَ قَوْلَهُ هَذَا :
سُرَاقَةُ لِلْقُرْآنِ يَدْرُسُهُ
وَلَيْسَ نَظِيرَ مَا مُثِّلَ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ : لِزَيْدٍ ضَرَبْتُ ، أَيْ زَيْدًا ضَرَبْتُ ; لِأَنَّ ضَرَبْتُ فِي هَذَا الْمِثَالِ لَمْ يَعْمَلْ فِي ضَمِيرِ زَيْدٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ عَامِلٌ فِي : " لِكُلِّ وِجْهَةٍ " يُفَسِّرُهُ قَوْلُهُ : " مُوَلِّيهَا " ، كَتَقْدِيرِنَا زَيْدًا أَنَا ضَارِبُهُ ، أَيْ أَضْرِبُ زَيْدًا أَنَا ضَارِبُهُ ، فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ بَابِ الِاشْتِغَالِ ; لِأَنَّ الْمُشْتَغَلَ عَنْهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُجَرَّ بِحَرْفِ الْجَرِّ . تَقُولُ : زَيْدًا مَرَرْتُ بِهِ ، أَيْ لَابَسْتُ زَيْدًا ، وَلَا يَجُوزُ : بِزَيْدٍ مَرَرْتُ بِهِ ، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ : مَرَرْتُ بِزَيْدٍ مَرَرْتُ بِهِ ، بَلْ كُلُّ فِعْلٍ يَتَعَدَّى بِحَرْفِ الْجَرِّ ، إِذَا تَسَلَّطَ عَلَى ضَمِيرِ اسْمٍ سَابِقٍ فِي بَابِ الِاشْتِغَالِ ، فَلَا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ الِاسْمِ السَّابِقِ أَنْ يُجَرَّ بِحَرْفِ جَرٍّ ، وَيُقَدَّرُ ذَلِكَ الْفِعْلِ لِيَتَعَلَّقَ بِهِ حَرْفُ الْجَرِّ ، بَلْ إِذَا أَرَدْتَ الِاشْتِغَالَ نَصَبْتَهُ ، هَكَذَا جَرَى كَلَامُ الْعَرَبِ . قَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=31وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ) . وَقَالَ الشَّاعِرُ :
أَثَعْلَبَةَ الْفَوَارِسِ أَمْ رَبَاحًا عَدَلْتَ بِهِمْ طُهَيَّةَ وَالْخِشَابَا
وَأَمَّا تَمْثِيلُهُ : لِزَيْدٍ أَبُوهُ ضَارِبُهُ ، فَتَرْكِيبٌ غَيْرُ عَرَبِيٍّ . فَإِنْ قُلْتَ : لِمَ لَا تَتَوَجَّهُ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ عَلَى أَنَّ " لِكُلٍّ وِجْهَةٍ " فِي مَوْضِعِ الْمَفْعُولِ الثَّانِي " لِمُوَلِّيهَا " ، وَالْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ هُوَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ اسْمُ الْفَاعِلِ الَّذِي هُوَ مُوَلٍّ ، وَهُوَ الْهَاءُ ، وَتَكُونُ عَائِدَةٌ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَاتِ وَالطَّوَائِفِ ، وَأَنَّثَ عَلَى مَعْنَى الطَّوَائِفِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ ، وَيَكُونُ التَّقْدِيرُ : وَكُلُّ وِجْهَةٍ اللَّهُ مُوَلِّي الطَّوَائِفَ أَصْحَابَ الْقِبْلَاتِ ؟ فَالْجَوَابُ : أَنَّهُ مَنَعَ هَذَا التَّقْدِيرَ نَصُّ النَّحْوِيِّينَ عَلَى أَنَّ الْمُتَعَدِّيَ إِلَى وَاحِدٍ هُوَ الَّذِي يَجُوزُ أَنْ تَدْخُلَ اللَّامُ عَلَى مَفْعُولِهِ إِذَا تَقَدَّمَ . أَمَّا مَا يَتَعَدَّى إِلَى اثْنَيْنِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا اللَّامُ إِذَا تَقَدَّمَ ، وَلَا إِذَا تَأَخَّرَ . وَكَذَلِكَ مَا يَتَعَدَّى إِلَى ثَلَاثَةٍ . وَمُوَلٍّ هُنَا اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ فِعْلٍ يَتَعَدَّى إِلَى اثْنَيْنِ ، فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ هَذَا التَّقْدِيرُ . وَقَالَ
ابْنُ عَطِيَّةَ ، فِي تَوْجِيهِ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ : أَيْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ لِكُلِّ وُجْهَةٍ وَلَاكِمُوهَا ، وَلَا تَعْتَرِضُوا فِيمَا أَمَرَكُمْ بَيْنَ هَذِهِ وَهَذِهِ ، أَيْ إِنَّمَا عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ فِي الْجَمِيعِ . وَقَدَّمَ قَوْلَهُ : " لِكُلِّ وِجْهَةٍ " عَلَى الْأَمْرِ فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=148فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ " ; لِلِاهْتِمَامِ بِالْوِجْهَةِ ، كَمَا تَقَدَّمَ الْمَفْعُولُ . انْتَهَى كَلَامُ
ابْنِ عَطِيَّةَ ، وَهُوَ
[ ص: 439 ] تَوْجِيهٌ لَا بَأْسَ بِهِ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=148فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ) : هَذَا أَمْرٌ بِالْبِدَارِ إِلَى فِعْلِ الْخَيْرِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ . وَنَاسَبَ هَذَا أَنَّ مَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ شَرِيعَةً ، أَوْ قِبْلَةً ، أَوْ صَلَاةً ، فَيَنْبَغِي الِاهْتِمَامُ بِالْمُسَارَعَةِ إِلَيْهَا . قَالَ
قَتَادَةُ : الِاسْتِبَاقُ فِي أَمْرِ الْكَعْبَةِ رَغْمًا لِلْيَهُودِ بِالْمُخَالَفَةِ . وَقَالَ
ابْنُ زَيْدٍ : مَعْنَاهُ : سَارِعُوا إِلَى الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مِنَ التَّوَجُّهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى : فَاسْتَبِقُوا الْفَاضِلَاتِ مِنَ الْجِهَاتِ ، وَهِيَ الْجِهَاتُ الْمُسَامِتَةُ لِلْكَعْبَةِ ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ . وَذَكَرْنَا أَنَّ اسْتَبِقْ بِمَعْنَى : تَسَابَقْ ، فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى الِاشْتِرَاكِ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=17إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ ) ، أَيْ نَتَسَابَقُ ، كَمَا تَقُولُ . تَضَارَبُوا . وَاسْتَبَقَ لَا يَتَعَدَّى ; لِأَنَّ تَسَابَقَ لَا يَتَعَدَّى ، وَذَلِكَ أَنَّ الْفِعْلَ الْمُتَعَدِّيَ ، إِذَا بَنَيْتَ مِنْ لَفْظٍ مَعْنَاهُ : تَفَاعَلَ لِلِاشْتِرَاكِ ، صَارَ لَازِمًا ، تَقُولُ : ضَرَبْتُ زَيْدًا ، ثُمَّ تَقُولُ : تَضَارَبْنَا ، فَلِذَلِكَ قِيلَ : إِنَّ " إِلَى " هُنَا مَحْذُوفَةٌ ، التَّقْدِيرُ : فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ . قَالَ
الرَّاعِي :
ثَنَائِي عَلَيْكُمْ آلَ حَرْبٍ وَمَنْ يَمِلْ سِوَاكُمْ فَإِنِّي مُهْتَدٍ غَيْرُ مَائِلِ
يُرِيدُ وَمَنْ يَمِلْ سِوَاكُمْ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=148أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ) : هَذِهِ جُمْلَةٌ تَتَضَمَّنُ وَعْظًا وَتَحْذِيرًا وَإِظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ ، وَمَعْنَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=148يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ) : أَيْ يَبْعَثُكُمْ وَيَحْشُرُكُمْ لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ ، فَأَنْتُمْ لَا تُعْجِزُونَهُ ، وَافَقْتُمْ أَمْ خَالَفْتُمْ ، وَلِذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَقِيلَ : الْمَعْنَى : أَيْنَمَا تَكُونُوا مِنَ الْجِهَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ، أَيْ يَجْمَعُكُمْ وَيَجْعَلُ صَلَاتَكُمْ كُلَّهَا إِلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَكَأَنَّكُمْ تُصَلُّونَ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=148إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) تَقَدَّمَ شَرْحُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ ، وَسِيقَتْ بَعْدَ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِلْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ ، أَيْ لَا يُسْتَبْعَدُ إِتْيَانُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْأَشْلَاءِ الْمُتَمَزِّقَةِ فِي الْجِهَاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ ، فَإِنَّ قُدْرَةَ اللَّهِ تَتَعَلَّقُ بِالْمُمْكِنَاتِ ، وَهَذَا مِنْهَا . وَقَدْ تَقَدَّمَ لَنَا أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ الْمُصَدَّرَةِ بِأَنْ تَجِيءُ كَالْعِلَّةِ لِمَا قَبْلَهَا ، فَكَانَ الْمَعْنَى : إِتْيَانُ اللَّهِ بِكُمْ جَمِيعًا لِقُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ .
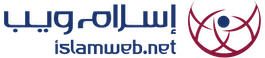
 المكتبة الإسلامية
المكتبة الإسلامية موسوعة التربية
موسوعة التربية كتاب الأمة
كتاب الأمة حول المكتبة
حول المكتبة قائمة الكتب
قائمة الكتب عرض موضوعي
عرض موضوعي تراجم الأعلام
تراجم الأعلام














 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات