
لما كانت سورة الفاتحة هي مفتتح الصلاة، وأحد أركانها التي تدور على لسان المصلي في كل ركعة، كان لا بد على المسلم الاعتناء بها لفظا، بحيث يتقن تلاوتها ولا يلحن فيها، والاعتناء بها معنى، بحيث يفهم أهم معانيها ومقاصدها لتفعيل أثرها في النفس، وتجديد وقعها على قلب المصلي.
وهذه بعض المعاني المختصرة لكلمات الفاتحة من عدة تفاسير ومن أهمها تفسير الفاتحة لابن عثيمين:
"بسم الله الرحمن" أي: ذو الرحمة الواسعة، "الرحيم" أي: الموصل للرحمة من يشاء من عباده، فكل ما حصل من نعمة، أو اندفع من نقمة فهو من آثار رحمة الله.
"الحمد": وصف المحمود - وهو الله- بالكمال مع المحبة والتعظيم، فقد يثني الإنسان على ملك لكن من غير محبة ولا تعظيم، بل لنيل عطاء أو لخوف أذى، وهذا لا يسمى حمدا، أما المصلي إذا قال الحمد لله، فهو يثني على الله بكمالاته مع كمال الحب وكمال الذل والتعظيم.
"لله": الله اسم ربنا عزّ وجلّ؛ لا يسمى به غيره؛ ومعناه: المألوه، أي: المعبود حباً، وتعظيماً.
"رب": الرب: هو من اجتمع فيه ثلاثة أوصاف: الخلق، والملك، والتدبير؛ فهو الخالق المالك لكل شيء المدبر لجميع الأمور.
"العالمين": جمع عالَم، وهم من سوى الله، وسموا بذلك لكونهم عَلَم على خالقهم، فكل مخلوق هو آية على قدرة الله وحكمته وقدرته.
وحين يقول المصلي: "الحمد لله"، فهو يستشعر كمال الحمد الذي تفيده أل، فله سبحانه الحمد الكامل، وله الاختصاص بذلك من جميع الوجوه، وله الحمد بجميع الأحوال، وليس ذلك إلا لله، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» ، وإذا رأى ما يكره قال: «الحمد لله على كل حال». رواه ابن ماجة من حديث عائشة.
وأما مناسبة الوصف بالرحمة بعد الربوبية فإنه لما أثبت لنفسه الربوبية في قوله: "رب العالمين" بين نوع تلك الربوبية وأنها مبنية على الرحمة بالخلق، فقال: "الرحمن الرحيم".
"مالك يوم الدين": أي مالك يوم الجزاء وهو يوم القيامة، وإنما خص يوم القيامة مع أنه مالك الدنيا والآخرة؛ لأن فيه يظهر ملكه وسلطانه لكل الناس، ففي الدنيا قد لا يكون هذا الظهور للجميع لوجود من يدعي الملك ممن يتوهمون أنهم ملوك على الحقيقة، أما في الآخرة فيظهر تفرده بالملك دون تشويش أو خفاء.
وهذا الوصف يجعل المصلي يحسن صلاته لأنه واقف بين يدي ملك يوم الدين الذي سيجزيه على صلاته إن أحسن فيها بأحسن الجزاء، وفي ذلك عون له على إخلاص نيته، فهو يصلي لمالك يوم الدين، فيهون في قلبه مقام كل ملوك الدنيا فضلا عمن سواهم.
"إِيَّاكَ نَعْبُدُ": معناه: لا نعبد إلا إياك، والعبادة هنا بمعنى الذل والخضوع، فهو وحده الذي يخضع له العباد، "وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ": أي لا نستعين إلا إياك على العبادة، وغيرها.
وفي هذه الآية بجزأيها إخلاص العبادة لله، وإخلاص الاستعانة بالله عزّ وجلّ، والاستعانة هنا بمعنى الاعتماد على الله والتبرؤ من الحول والقوة، وهذا لا يكون إلا لله تعالى.
"إهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ": دلنا ووفقنا وثبتنا على الصراط المستقيم، وهو الإسلام وطريق النجاة الموصل إلى الجنة.
وطلب الهداية يعني سؤال العلم النافع الموصل إلى معرفة الله وتعظيمه وخشيته، ويعني طلب التوفيق والإلهام للعمل الصالح، إذ قد يتبين للإنسان طريق الهدى، ولكنه لا يوفق ولا يلهم الاستقامة، فالعبد يسأل الله الهداية في العلم والعمل.
"غير المغضوب عليهم": هم اليهود، وكل من علم بالحق ولم يعمل به، فالمصلي يدعو الله بأن يجنبه سبيلهم، وأن لا يكون ممن يعلم الحق ويكتمه ويعدل عنه إلى الباطل، فهذه من صفات اليهود، وفي الآية تحذير للمسلم من ذلك.
"ولا الضالين": هم النصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من عمل بغير الحق جاهلاً به، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقد علموا الحق، وقامت عليهم الحجة ببعثته، ولكنهم عدلوا عنه إلى الباطل.
وفي ذلك اعتراف العبد بأن الهداية إنما هي فضل من الله تعالى ومحض منته على من يشاء من عباده من غير استحقاق ولا إيجاب، فيبقى العبد يطلب الهداية ويطلب المزيد منها والثبات عليها، خائفا من زوالها، مستمسكا بأسبابها.
قال ابن كثير في تفسيره: ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافاً يعني: أن اليهود هم المغضوب عليهم، والنصارى هم الضالون.
ومما يعين المصلي على تفهم معاني الفاتحة، والتفاعل مع آياتها العظيمة هو استحضار رجع الكلمات الذي يحصل بين العبد وبين ربه عند تلاوة تلك الآيات، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج« ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: «اقرأ بها في نفسك» ؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: {الحمد لله رب العالمين} ، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: {الرحمن الرحيم} ، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: {مالك يوم الدين} ، قال: مجدني عبدي - وقال مرة فوض إلي عبدي - فإذا قال: {إياك نعبد وإياك نستعين} قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: {اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل».
ومن أعظم مقاصد الفاتحة: الثناء على الله تعالى، ولذلك استفتحت السورة بثلاث آيات في الحمد والثناء والتمجيد، وهو باب الوصول إلى الله، والظفر بالقبول وإجابة الدعاء، ولا غرابة فإن الصلاة كلها إنما شرعت لأجل ذلك.
قال ابن القيم في الصواعق: ولما كان حمده والثناء عليه وتمجيده هو مقصود الصلاة التي هي عماد اإسلام ورأس الطاعات شرع في أولها ووسطها وآخرها وجميع أركانها ففي دعاء الاستفتاح يحمد ويثنى عليه ويمجد وفي ركن القراءة يحمد ويثنى عليه ويمجد وفي الركوع يثنى عليه بالتسبيح والتعظيم وبعد رفع الرأس منه يحمد ويثنى عليه ويمجد وفي السجود يثنى عليه بالتسبيح المتضمن لكماله المقدس والعلو المتضمن لمباينته لخلقه وفي التشهد يثنى عليه بأطيب الثناء من التحيات ويختم ذلك بذكر حمده ومجده.



 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج استشارات الحج
استشارات الحج

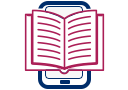












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات